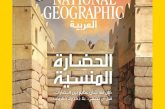المسلة السياحية
بكين 16 سبتمبر 2021 (شينخوا) – جاء في مقال رأي نشرته صحيفة ((نيويورك تايمز)) في أكتوبر 2020 أنه “في أوائل القرن الـ21، إذا كانت هناك أي قوة سعت للهيمنة على العالم وقسر الآخرين وانتهاك القواعد، فهي الولايات المتحدة”.
منذ إعلان الاستقلال في عام 1776، كانت الولايات المتحدة عازمة على توسيع أراضيها ونفوذها. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تدخر الولايات المتحدة أي جهد للسعي وراء الهيمنة العالمية والاحتفاظ بها. وسخَّرت الولايات المتحدة تفوقها المطلق في قطاعات العسكرية والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة، للتدخل كثيرا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتنمرت على الدول الأخرى ونهبتها وسيطرت عليها تحت شعار “الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وفي حقبة ما بعد الحرب، اتبعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة استراتيجيات الهيمنة. وانطلاقا من مبدأ ترومان، المعروف أيضا باسم سياسة الاحتواء، ووصولا إلى السياسات الخارجية للإدارات الأمريكية الحديثة، بما في ذلك استراتيجية باراك أوباما المعروفة باسم “القوة الذكية”، وسياسة “أمريكا أولا” التي أعلنها دونالد ترامب، وخطة “إعادة البناء بشكل أفضل” التي وضعها جو بايدن، فإن الهدف دائما هو تأمين الهيمنة الأمريكية.
وعملت الولايات المتحدة على تأجيج التوترات في جميع أنحاء العالم من خلال شن الحروب وإثارة المواجهات والإطاحة بالحكومات الأجنبية باستخدام القوات المسلحة، وإشعال الحروب والاضطرابات في العديد من البلدان والمناطق. ومن خلال اعتناق ما يسمى بـ”الاستثنائية الأمريكية”، أفرطت البلاد في استخدام معايير مزدوجة مع عدم مراعاة القوانين والقواعد الدولية، حيث أعاقت بشدة التعاون الدولي من خلال الاستفادة من المنظمات والاتفاقيات الدولية لملاءمة احتياجاتها، مع التخلي عما يتعارض مع مصالحها؛ فمن خلال التلاعب بالنظام المالي الدولي، استحوذت الولايات المتحدة على ثروة هائلة بينما كانت تغض الطرف عن الجشع والمضاربة، ما أدى إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة بشكل صارخ سلطة قضائية طويلة الذراع، لتشعل نزاعات تجارية مع العديد من الدول الأخرى، ولم تتوقف عند أي شيء لقمع أولئك الذين تعتبرهم خصوما. وحاولت التلاعب بالرأي العام العالمي في الوقت الذي حاولت فيه تصدير قيمها لدول أخرى وشن غزوات ثقافية فيها.
إنها أكبر مخرب للقواعد الدولية والنظام الدولي، ومصدر تزايد عدم اليقين وعدم الاستقرار في العالم. لقد قوضت الهيمنة وسياسة القوة اللتان تنتهجهما واشنطن، النظام العالمي، وهددتا السلام البشري، وتسببت في عواقب وخيمة على العالم، وبالتالي أصبحت تلك الهيمنة والسياسة التحدي الأكبر لتقدم المجتمع البشري والحضارة، وكذلك التنمية السلمية.
دولة محاربة
لطالما كانت الولايات المتحدة دولة محاربة. بعد إعلان استقلالها في 4 يوليو 1776، وعلى مدى تاريخها الذي يزيد عن 240 عاما، كانت البلاد دوما في حالة حرب عدا فترة تقل عن 20 عاما.
و في أكتوبر 2018، أشار داكوتا وود، الزميل البحثي البارز المتخصص في برامج الدفاع بمركز الدفاع الوطني التابع لمؤسسة التراث الأمريكية، إلى أنه “كل 15 عاما أو نحو ذلك”، تدخل الولايات المتحدة في صراع.
وللحفاظ على هيمنتها، انتهكت الولايات المتحدة بشكل صارخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي مرات عديدة.
وبالاعتماد على قوتها العسكرية، تدخلت الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وخلقت صراعات من خلال شن الحروب وتنفيذ استراتيجيات الاحتواء والتخطيط لما يسمى بـ”التطورات السلمية” و”الثورات الملونة”، ما يهدد السلام العالمي بشدة.
ومنذ الحرب العالمية الثانية، شنت الولايات المتحدة أو شاركت في حروب في شبه الجزيرة الكورية وفيتنام وكوسوفو وأفغانستان والعراق وأماكن أخرى، وهي الحروب التي لم تسفر عن مقتل العديد من الجنود فحسب، بل تسببت أيضا في خسائر فادحة في صفوف المدنيين وخسائر في الممتلكات، ما أدى إلى كوارث إنسانية فادحة.
الحرب على العراق
وفي عام 2003، وعلى الرغم من المعارضة الواسعة من المجتمع الدولي، شنت الولايات المتحدة الحرب على العراق بتهم لا مبرر لها، ما أسفر عن مقتل ما يتراوح بين 180 ألفا و200 ألف مدني عراقي، وفقا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة.
كما استخدمت قوات التحالف ذخائر اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض في العراق، ما عرّض البيئة المحلية وصحة الناس لخطر كبير.
ووفقا لتقرير أصدرته في مارس 2021 مجموعة (كود بينك)، وهي مجموعة أمريكية مناهضة للحرب، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها واصلوا قصف دول أخرى على مدار العشرين عاما الماضية، حيث أسقطوا في المتوسط أكثر من 40 قنبلة في اليوم. وفي أواخر فبراير 2021، بعد نحو شهر من تولي إدارة بايدن السلطة، شن الجيش الأمريكي ضربات جوية على شرقي سوريا، ما أثار إدانة قوية من العديد من الأطراف.
ويعزز الإنفاق العسكري المرتفع المستمر للبلاد، ذلك القصف العشوائي الذي ينفذه الجيش الأمريكي في الخارج.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقرير نُشر في أبريل: “في عام 2020، بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي ما يقدر بـ778 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة بعام 2019”.
وقال التقرير “باعتبارها الدولة صاحبة أكبر إنفاق عسكري في العالم، استحوذت الولايات المتحدة على 39 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020. وكان هذا العام الثالث على التوالي من النمو في الإنفاق العسكري الأمريكي”.
وكتب ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، على الموقع الإلكتروني لمجلة ((فورين بوليسي)): “الحملات التي لا نهاية لها في الخارج تطلق العنان لمجموعة من القوى السياسية –العسكرية والسرية والسلطة التنفيذية المعززة، وكراهية الأجانب، والوطنية الزائفة، والديماغوغية، وما إلى ذلك– وكلها تتعارض مع الفضائل المدنية التي تعتمد عليها الديمقراطية الصحيحة”.
ووفقا لمقال نشره مركز التقدم الأمريكي، وهو منظمة أبحاث ودعوة معنية بالسياسة العامة الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، فإن ميزانية الدفاع الأمريكية اليوم، عند تعديلها وفقا للتضخم، أعلى مما أنفقته الولايات المتحدة في ذروة الحرب الباردة، وهي حاليا أكثر من مجموع ميزانيات الدفاع لأكبر 10 دول في العالم بعد الولايات المتحدة، وتستهلك أكثر من نصف الميزانية التقديرية الإجمالية للحكومة الفيدرالية بأكملها.
ومع ذلك، قال المقال إنه “بغض النظر عن المبلغ الذي تنفقه الولايات المتحدة على الدفاع، لا يمكنها الحصول على أمن مثالي”.
الحرب على الإرهاب
يصادف هذا العام الذكرى العشرين للغزو الأمريكي لأفغانستان تحت شعار مكافحة الإرهاب. أعلن بايدن في 14 أبريل أن القوات الأمريكية ستنسحب بالكامل من أفغانستان قبل 11 سبتمبر، وفي 8 يوليو قدّم بايدن الموعد النهائي إلى 31 أغسطس.
وقال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إن الولايات المتحدة زعمت أنها حاربت التطرف وحققت الاستقرار في أفغانستان، لكنها فشلت على الجبهتين.
وبعد هجمات الـ11 من سبتمبر عام 2001، أصبحت مكافحة الإرهاب محور الأمن الوطني والسياسة الخارجية لأمريكا. ومنذ ذلك الحين، وبازدواجية معايير وعقلية الحرب الباردة، شنت الولايات المتحدة “الحرب على الإرهاب” في جميع أنحاء العالم تحت ذريعتي “الأمن الوطني” و”الدفاع عن الحرية”، وقسمت البلدان إلى معسكرات مختلفة، بل وأسقطت حكومات دول أخرى تحت ستار مكافحة الإرهاب.
لقد أصبحت عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة أداة للحفاظ على هيمنتها وتعزيز ما يسمى بالديمقراطية والقيم الأمريكية في الخارج، ما أدى إلى إلحاق الأذى بالعديد من المدنيين، وتفاقم قضية اللاجئين، وإغراق المناطق المتضررة في حالة من الفوضى، وزيادة التهديدات الأمنية.
وبصرف النظر عما يسمى بعمليات “مكافحة الإرهاب”، فقد انتهكت الولايات المتحدة بشكل صارخ حقوق الإنسان والحريات في الدول الأخرى، كما يتضح من الفضائح المروعة للانتهاكات التي ارتكبها الجيش الأمريكي ضد السجناء في أفغانستان والعراق.
وذكر مقال نُشر بمجلة ((سميثسونيان)) الأمريكية في أوائل عام 2019، أنه منذ عام 2001 “على عكس ما يعتقده معظم الأمريكيين، فإن الحرب على الإرهاب لا تهدأ — فقد امتدت إلى أكثر من 40 بالمئة من دول العالم”.
ووفقا لتقرير صدر في نوفمبر 2019 ضمن مشروع (تكاليف الحرب) في جامعة براون الأمريكية، فقد مات ما بين 770 ألفا و801 ألف شخص في حروب ما بعد 11 سبتمبر.
وشاركت حركة تركستان الشرقية الإسلامية منذ فترة طويلة في أنشطة انفصالية ومتطرفة وعنيفة مناهضة للصين، داخل الصين وخارجها، ما تسبب في خسائر بشرية فادحة وخسائر فادحة في الممتلكات للشعب الصيني. وأُدرجت الحركة على قائمة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267، وهو القرار الذي شاركت الولايات المتحدة في تأييده.
وفي السنوات الأخيرة، كانت الحركة تنشط في أفغانستان وسوريا وأماكن أخرى، وتخطط وتنفذ سلسلة من الأنشطة الإرهابية العنيفة، بما في ذلك هجوم بسيارة مفخخة على السفارة الصينية في قيرغيزستان عام 2016.
ومع ذلك، قامت الولايات المتحدة من جانب واحد برفع الحركة من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية في أواخر عام 2020، مدعية أنه لأكثر من عقد، لم يكن هناك دليل موثوق على استمرار وجود الحركة. لقد كشفت مثل هذه الخطوة بوضوح نية الولايات المتحدة الشريرة لاحتواء الصين بالإرهاب.
كما رعت الولايات المتحدة العديد من القوى المناهضة للحكومات في جميع أنحاء العالم، والتي أصبح العديد منها فيما بعد منظمات إرهابية ومرتكبي أنشطة إرهابية في جميع أنحاء العالم.
بعد الثورة الكوبية
وعلى سبيل المثال، بعد الثورة الكوبية، قامت الولايات المتحدة بإيواء العديد من الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة الكوبية، بل وسمحت لها بإقامة معسكرات تدريب في ولاية فلوريدا الجنوبية. وفي أكتوبر 1976، انفجرت طائرة ركاب كوبية فوق بربادوس، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 73 شخصا.
كان لويس بوسادا كاريليس، وهو من أصل كوبي ومنفي في الولايات المتحدة، متهما بالتسبب في الحادث وكان مطلوبا من جانب كوبا، لكن الحكومة الأمريكية رفضت دوما تسليمه إلى كوبا.
وفي ثمانينيات القرن العشرين، دعمت الولايات المتحدة بقوة رجال حرب العصابات المناهضين للحكومة في نيكاراغوا. وأدلى ستانسفيلد تورنر، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بشهادته أمام الكونغرس، قائلا: “أعتقد أن العديد من أعمال حرب العصابات أعمال إرهابية بطبيعتها وأعمال إرهابية تدعمها الولايات المتحدة، وهو أمر لا يمكن دحضه”.
غزو أفغانستان
ومن المفارقات أن الولايات المتحدة غزت أفغانستان في عام 2001 باسم مكافحة الإرهاب، لكنها في الحقيقة رعت الإرهاب. وخلال الحرب الباردة، استخدمت الولايات المتحدة أفغانستان أداة ضد الاتحاد السوفيتي، وقدمت كميات كبيرة من الأسلحة والأموال للجماعات المتطرفة، بما في ذلك قوات أسامة بن لادن، لتشجيعها على محاربة الاتحاد السوفيتي.
وبعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، تخلت الولايات المتحدة على الفور عن هؤلاء “الأصدقاء” غير المفيدين، ما جعل أفغانستان ملاذا للإرهاب والتطرف على الصعيد العالمي.
كتبت المؤسسة المشاركة لمجموعة (كود بينك)، الناشطة ميديا بنيامين، والباحث في المجموعة نيكولاس ديفيس، في مقال مشترك، ما مفاده أنه إذا استمرت إدارة بايدن في تكديس المزيد من الأكاذيب والفظائع كما فعلت الإدارات السابقة، “فلن تتمكن من استعادة احترام العالم للقيادة الأمريكية ولن تكسب تأييد الرأي العام الأمريكي لسياستها الخارجية”.
إدمان التدخل
للحفاظ على هيمنتها وتعزيزها، لجأت الولايات المتحدة إلى جميع الوسائل، من التغطية على “التطورات السلمية”، والتحريض على” الثورات الملونة”، حتى التخريب المباشر لحكومات الدول الأخرى.
وفي شهر يوليو من هذا العام، اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في أجزاء من كوبا. وتظهر الأدلة التي أصدرتها الحكومة الكوبية أنه منذ منتصف يونيو، قامت بعض القوى المناهضة لكوبا في الولايات المتحدة، بتمويل من الحكومة الأمريكية، بنشر الكذب عمدا عبر الشبكات الاجتماعية بأن النظام الطبي الكوبي، الذي هاجمه كوفيد-19، قد انهار، واستخدمت هذه الأكاذيب ذريعة للتحريض على التدخل العسكري في كوبا لتخريب الحكومة الكوبية.
وعقب ذلك صدرت عقوبات أمريكية ضد بعض المسؤولين العسكريين الكوبيين وكذا بعض الكيانات الكوبية على أساس ما يسمى “القمع الحكومي” للمتظاهرين.
وفي هذا العام، كشفت وسائل إعلام محلية في كوبا أنه في العقدين الماضيين، خصصت وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الوطني للديمقراطية، ما يقرب من 250 مليون دولار أمريكي لسلسلة من البرامج التخريبية التي تستهدف كوبا.
وفي اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز إن السلوك غير المسؤول للولايات المتحدة هو أكبر تهديد للسلام والأمن على الصعيد العالمي.
إن الولايات المتحدة لديها إدمان التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
وقال الكاتب الأمريكي ويليام بلوم في كتابه ((الديمقراطية أشد الصادرات الأمريكية فتكا))، إنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سعت الولايات المتحدة للإطاحة بأكثر من 50 حكومة أجنبية، معظمها منتخبة ديمقراطيا، وتدخلت بشكل صارخ في انتخابات ديمقراطية لـ30 دولة على الأقل، وحاولت اغتيال أكثر من 50 من القادة الأجانب.
وخلال الحرب الباردة، شنت الولايات المتحدة أنشطة التسلل والتحريض على التمرد وبث الاضطرابات والدمار ضد الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية.
الثورات الملونة
وبعد نهاية الحرب الباردة، روجت الولايات المتحدة بوقاحة أكثر للتدخل وصدرت في كثير من الأحيان “الثورات الملونة”. وفي نهاية عام 2003، أجبرت رئيس جورجيا آنذاك إدوارد شيفرنادزه على تقديم استقالته بسبب ما يسمى بـ”التزوير” في فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية. ويُعرف الحادث باسم “ثورة الورود”.
وفي أكتوبر 2004، قامت الولايات المتحدة بتلفيق فضيحة “التزوير” في الانتخابات الأوكرانية، وحرضت الشباب في البلاد على التظاهر في الشوارع، ودعمت وصول فيكتور يوشينكو إلى السلطة. وهذا ما يسمى “الثورة البرتقالية”.
وفي مارس 2005، حرضت الولايات المتحدة المعارضة في قيرغيزستان على الاحتجاج على نتائج الانتخابات البرلمانية، ما أدى في النهاية إلى أعمال شغب، قبل أن يُجبر رئيس قيرغيزستان عسكر أكاييف على الفرار وإعلان استقالته فيما يسمى بـ”ثورة التوليب”.
وفي العقد الماضي، تدخلت الولايات المتحدة مرارا وتلاعبت بـ”الثورات الملونة” في بعض البلدان في وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى وغرب آسيا وشمال إفريقيا.
وخلف سلسلة “الثورات الملونة” التي ترعاها الولايات المتحدة، ظهرت مؤسسة غير رسمية وغير هادفة للربح؛ وهي مؤسسة (الصندوق الوطني للديمقراطية) والمعروفة بأنها “الراعي الأكبر للثورات الملونة العالمية”.
وتأسست المنظمة عام 1983، ولديها علاقات وثيقة مع وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة الاستخبارات المركزية وما شابه ذلك.
تقدم هذه المؤسسة سنويا أكثر من 1600 منحة لدعم مشروعات المنظمات غير الحكومية في أكثر من 90 دولة. وتعد المؤسسة أيضا مصدر تمويل يدعم بعض القوات الانفصالية ضد الصين، حيث تدعم العشرات من المخططات المتعلقة بالصين سنويا.
وقدمت حتى الآن نحو 100 مليون دولار لأكثر من 100 مجموعة مناهضة للصين، بما في ذلك المجموعات التي حددتها الصين بوضوح على أنها منظمات إرهابية مثل ما يسمى بـ”مؤتمر شباب التبت” و”مؤتمر الويغور العالمي”.
كما جاءت الكثير من الأموال لأنشطة ما يسمى “استقلال هونغ كونغ” من هذه المؤسسة.
هيمنة الدولار
استغلت الولايات المتحدة هيمنة الدولار الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، لتحقيق مكاسب من خلق وتدفق ثروة العالم.
لقد استخدمت الولايات المتحدة هيمنة الدولار لزيادة المخاطر المالية التي تواجهها الدول النامية ونهب ثرواتها، من بينها الموارد والعقارات، والحصول على الحق في احتكار صناعات الخدمات العامة في هذه الدول، من بينها المياه والكهرباء والنقل.
ففي دول أمريكيا اللاتينية التي تبنت توافق واشنطن، انخفض معدل النمو الاقتصادي التسعينيات بواقع 50 بالمئة في المتوسط مقارنة بالثمانينيات.
لقد تلاعب “القتلة الاقتصاديون” الأمريكيون الذين يرتدون عباءة الاقتصاديين والمصرفيين والمستشارين الماليين الدوليين القانونية، بدول أخرى عن طريق الوسائل الاقتصادية، وخدعوا الدول النامية ليسقطوا في فخاخ اقتصادية معدة مسبقا، وسيطروا على شريان الحياة الاقتصادي والموارد الطبيعية لهذه الدول، وجعلوا الأموال تتدفق إلى الولايات المتحدة باستمرار، وعززوا ووسعوا هيمنة الولايات المتحدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في العالم، وفقا لما قال الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز في كتابه (اعترافات قاتل اقتصادي) الذي نشر عام 2004.
لطالما كانت هذه هي الحال في التجارة الدولية: الولايات المتحدة تطبع دولارات والدول الأخرى في العالم تحول الموارد والبضائع إلى دولارات في التجارة العالمية، ثم تشتري سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية للشركات بصفتها احتياطيات النقد الأجنبي، ما يمكن الدولار الأمريكي من التدفق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة ودعم الاقتصاد الأمريكي.
وقد وصف المؤرخ الأمريكي نيال فيرغسون هذه الظاهرة بأنها “أكبر غداء مجاني في التاريخ الاقتصادي الحديث”.
وعلى الرغم من تضخم العجز المالي ودين الحكومة، لا تزال الديون الأمريكية تتمتع بمعدلات فائدة منخفضة بفضل هيمنة الدولار الأمريكي، ما يسمح للولايات المتحدة بجمع الأموال من حول العالم بتكاليف منخفضة جدا.
و بالاعتماد على هيمنة الدولار، أصبحت الولايات المتحدة تتمتع بامتياز طباعة النقود دون قيود تقريبا.
وبعد الأزمة المالية عام 2008، أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث جولات من سياسات التيسير الكمي منذ نهاية 2008 حتى أكتوبر 2014، مما أدى إلى تحويل الأزمة إلى العالم كله من خلال الإفراط في إصدار الدولارات.
ومنذ تفشي كوفيد-19، عاد البنك مرة أخرى إلى وضع “التيسير الفائق” الذي يجسد معدل فائدة صفري وتيسير كمي غير محدود من أجل تحفيز الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم. وبعد تولي إدارة بايدن السلطة، تم طرح خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، سريعا.
والجدير بالذكر هو أنه في كل مرة ينقذ فيها البنك السوق الأمريكية، لا يعود النفع على الأشخاص العاديين وإنما يعود على واحد بالمئة من الصفوة الأمريكية، الذين يحصلون تقريبا على جميع أرباح الولايات المتحدة القادمة من حول العالم.
وتضم النسبة أكثر المجموعات قوة والممولة جيدا، من بينها شركات الإنترنت العملاقة، ووول ستريت، وصناعة التأمين الصحي، وشركات الأدوية، وصناعة الوقود الأحفوري، و المجمع العسكري-الصناعي.
توسعت الصناعات المالية وصناعات التكنولوجيا الفائقة الأمريكية سريعا خلال جائحة كورونا، وحصلت شركات أمريكية كبيرة على إعانات هائلة من حزم التحفيز الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، تدفقت معظم الدولارات الزائدة إلى سوق الأسهم، مما أدى إلى زيادة تضخم ثروة الأثرياء.
ووفقا لبيانات نشرها موقع ((فوربس)) الأمريكي في يناير هذا العام، على الرغم من أن عشرات الملايين من الأمريكيين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كورونا العام الماضي، فإن الثروة الإجمالية لما يزيد على 650 ملياردير أمريكي زادت 1.3 تريليون دولار، زيادة بواقع 38.6 بالمئة، بينما زادت ثروة أغنى خمسة أمريكيين من 358 مليار دولار إلى 661 مليار دولار في الإجمالي، زيادة بنسبة 85 بالمئة.
لقد خلقت طباعة الأموال بشكل جنوني وهم الرخاء المؤقت في الولايات المتحدة، لكنها تحمل مخاطر كبيرة.
يتجاوز كشف الميزانية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الآن 8 تريليونات دولار، ويقف الدين الوطني الأمريكي عند 28.5 تريليون دولار، وقد خفضت وكالة فيتش توقعها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة إلى “سلبي” في يوليو 2020، قائلة إن ارتفاع الديون والعجز أدى إلى تآكل الائتمان السيادي للولايات المتحدة.
ستؤدي ممارسة الولايات المتحدة لطباعة النقود لجعل دول أخرى “تدفع” عنها عجزها، إلى تعرض هيمنة الدولار الأمريكي للخطر في النهاية.
وخلال السنوات القليلة الماضية، من أجل التخلص من هيمنة الدولار، سرعت روسيا والاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الدولار.
وقال جورج سوروس في عام 2018، إن الدولار سيخسر وضعه بصفته العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم ووسيلة تبادل خلال السنوات القليلة المقبلة.
الولاية القضائية طويلة الذراع
قدم فريديريك بيروتشي المدير التنفيذي السابق لشركة (ألستوم)، في كتابه الذي نشر عام 2019 بعنوان “الفخ الأمريكي” وصفا مباشرا ومعلومات مباشرة لقمع واشنطن للشركة تحت مسمى مكافحة الفساد.
وقد أشار في الكتاب إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من تفكيك العديد من الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات الكبيرة خلال أكثر من عقد، تحت ذريعة مكافحة الفساد.
وخلال السنوات الماضية، استغلت واشنطن وسائل من بينها، الولاية القضائية طويلة الذراع والعقوبات الاقتصادية، لاحتواء أعدائها والدول المنافسة، ما يؤدي إلى إعاقة تنميتهم للحفاظ على سيادتها.
فعلى سبيل المثال، سنت الولايات المتحدة قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لتوسيع عقوباتها ضد روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيران. وفعلت المادة الثالثة من قانون هيلمز-بورتون لتعزيز الحظر الذي تفرضه على كوبا وفرضت عقوبات أحادية على شركات أجنبية لها علاقات اقتصادية مع كوبا.
وقد واصلت الولايات المتحدة توسيع نطاق تطبيق قوانينها المحلية خارج الحدود ووضعت أفرادا أجانب وكيانات أجنبية تحت ولايتها القضائية بشكل قسري، متجاهلة قواعد الولاية القضائية في القانون الدولي.
ووفقا لقوانينها المحلية، تمتلك الولايات المتحدة حق الوصول إلى بيانات المستخدمين ونقل معلومات من بنوك أوروبية عديدة عن طريق جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
وخلال السنوات القليلة الماضية، هاجمت وزارة العدل الأمريكية والجهات التنظيمية المالية ذات الصلة شركات أوروبية بشكل مستمر، وتم اتهام بعض الشركات “بالفساد” أو انتهاك الحظر الأمريكي للتجارة مع كوبا وليبيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيران ودول أخرى، وتم تغريمها مئات الملايين أو حتى مليارات الدولارات، بحسب علي لايدي، باحث في المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية.
وقد أدت هذه الأفعال إلى إلحاق مشقة مروعة وأزمات إنسانية لم تكن أقل تدميرا من الحروب، ببعض الدول. فمنذ ظهور جائحة كورونا، شهدت فنزويلا وسوريا وإيران، الدول التي تخضع للعقوبات الأمريكية منذ فترة طويلة، تدهورا في الأوضاع الاقتصادية والطبية، بالإضافة إلى الوضع الوبائي الحاد في الداخل. ومع ذلك، استمرت واشنطن في فرض العقوبات، مما أدى إلى زيادة الوضع سوءا في هذه الدول.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في ذلك الوقت في سبتمبر 2020 إن “الأمريكيين ألحقوا أضرارا بالشعب الإيراني تقدر بـ150 مليار دولار، بسبب العقوبات غير القانونية وغير الإنسانية”.
لقد حرفت الولايات المتحدة القواعد الاقتصادية لتستخدمها عندما تتناسب مع مصالحها.
وفي ظل إدارة ترامب، رفضت الولايات المتحدة رسميا وضع اقتصاد السوق للصين في الوثائق التي تم تقديمها لمنظمة التجارة العالمية وأثارت نزاعات تجارية مع الصين، وفرضت سلسلة من العقوبات الأحادية على شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية، بهدف تقويض أمن الصين واستقرارها وكبح تنميتها.
وبعد تولي بايدن السلطة، واصلت إدارته إساءة استخدام سلطة الدولة، وقدمت سلسلة من مشروعات القوانين والأوامر التنفيذية لقمع وتقييد شركة (هواوي) وشركات صينية أخرى بكل الوسائل الممكنة.
كما قمعت الولايات المتحدة حلفاءها. فبعد الحرب العالمية الثانية، واجه النمو الاقتصادي السريع في اليابان قمعا لا يرحم من الولايات المتحدة، كما ظهر في اتفاق بلازا.
وخلال بناء خط أنابيب (نورد ستريم 2) بين روسيا وألمانيا، افترضت الولايات المتحدة أن المشروع يضر بمصالحها في المنطقة، وفرضت عدة جولات من العقوبات لعرقلة تقدم المشروع، ما أثار استياء شديدا من حلفائها الأوروبيين، من بينهم ألمانيا.
عرقلة النظام الدولي
اعتمادا على قوتها العظمى، تستخدم الولايات المتحدة “الاستثنائية الأمريكية” أساسا نظريا لتطأ بقدميها على العلاقات الدولية بشكل جائر.
وبينما تطلب من الدول الأخرى الالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد، فإنها تضع مصالحها الخاصة منذ فترة طويلة فوق النظام الدولي القائم على القانون الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة.
ورغم أن الولايات المتحدة قادت إنشاء أنظمة وقواعد دولية للحوكمة السياسية والاقتصادية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها عادة ما تخرق القواعد وتنسحب من المنظمات الدولية طالما أنها لا تفي بمتطلبات الولايات المتحدة.
ومنذ الثمانينيات، ترفض الولايات المتحدة التصديق على العديد من المعاهدات أو تنسحب منها ومنظمات دولية من جانب واحد، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، وبروتوكول كيوتو.
وكانت إدارة ترامب متعمدة بشكل خاص سحب الولايات المتحدة من أكثر من 10 منظمات واتفاقيات دولية في غضون أربع سنوات، مثل مجلس حقوق الإنسان الدولي، وخطة العمل الشاملة المشتركة، ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي عارضت المفاوضات بشأن بروتوكول التحقق لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، ما أعاق جهود المجتمع الدولي للتحقق من الأنشطة البيولوجية في مختلف البلدان، وأصبح حجر عثرة في سبيل ضبط التسلح البيولوجي.
لم تنسحب الولايات المتحدة كثيرا من المجموعات الدولية فحسب، بل عاقبت أيضا أي مجموعة تجرأت على تحديها.
ففي عام 2020، أعلنت إدارة ترامب أنها ستفرض عقوبات اقتصادية وقيود سفر على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق في الإجراءات الأمريكية في الحرب الأفغانية ــ في خطوة هي الأسوأ من رفضها السابق الاعتراف بأحكام المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها، أو التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أظهر هذا مجددا أن الولايات المتحدة تفضل تدمير “الأسلحة العامة” إذا لم يكن من الممكن استخدامها لأغراضها الخاصة.
وقد عاودت إدارة بايدن الانضمام إلى بعض المنظمات والاتفاقيات الدولية لخدمة استراتيجياتها الوطنية فحسب، وابتعدت عن الاتفاقيات التي تعتقد أنها تضر بمصالحها، مثل معاهدة السماوات المفتوحة. وبينما روجت إدارة بايدن لـ”التعددية الانتقائية”، تم التعليق عليها من جانب بعض وسائل الإعلام الأوروبية على أنها “أمريكا أولا 2.0”.
في الواقع، لم تُظهر الولايات المتحدة أبدا أي تعاطف مع دول أو خصوم أو حلفاء آخرين، إذا كانوا لا يخدمون مصالح الولايات المتحدة. وفي الأعوام الأخيرة، دأبت الولايات المتحدة على مطالبة الناتو وحلفائه الآسيويين بزيادة إنفاقهم العسكري ودفع المزيد من “رسوم الحماية” للولايات المتحدة لإرسال قواتها.
وقبل رحلة بايدن إلى أوروبا في يونيو، تم الكشف عن تجسس الولايات المتحدة على سياسيين من حلفائها الأوروبيين، وهي فضيحة أخرى بعد مشروع (بريسم) في عام 2013.
وأظهر ذلك مجددا أن الولايات المتحدة كانت تنفذ أنشطة مراقبة واسعة النطاق وهجمات سيبرانية على مستوى العالم لفترة طويلة، وأنها، بصفتها إمبراطورية حقيقية من القراصنة، باتت أكبر تهديد للأمن السيبراني العالمي.
وتشبه جائحة كوفيد-19 مرآة سحرية كشفت قبح سياسة “أمريكا أولا”. لقد انخرطت الولايات المتحدة في الأحادية منذ تفشي الجائحة: فقد صادرت إمدادات مكافحة المرض الموجهة إلى دول أخرى، وفرضت حظرا على إمداداتها الطبية، واشترت كل القدرات الإنتاجية للعقاقير التي يمكن استخدامها لعلاج المرض.
لقد صدمت أفعالها الأنانية العالم وألحقت أضرارا بالغة بالتعاون العالمي لمكافحة المرض.
وفي حين أن اللقاحات قد منحت الأمل في المعركة العالمية ضد المرض، فقد تمسكت الولايات المتحدة بـ”قومية اللقاحات”، وسارعت لطلب وشراء اللقاحات، حتى تلك التي لا تزال تخضع للتجارب السريرية، ووضعت بعض البلدان والمناطق الأقل نموا في وضع يائس دون القدرة على الوصول إلى اللقاحات.
في غضون ذلك، كانت الولايات المتحدة تلحق شروطا سياسية بمساعدتها المقدمة في مجال اللقاحات.
وذكر موقع صحيفة ((إل موندو)) الإسبانية في افتتاحية إن واشنطن قدمت لقاحات للمكسيك مقابل تشديد السيطرة على المهاجرين غير الشرعيين على حدود جواتيمالا.
وعلقت مجلة ((فورين بوليسي)) الأمريكية التي تصدر كل شهرين، عبر موقعها على الإنترنت، قائلة إن إدارة بايدن لا تزال تسعى نحو تحقيق المصالح الأمريكية على حساب مصالح الدول الأخرى حول العالم.
وقد أنشأت الولايات المتحدة سرا مختبرات بيولوجية في العديد من الأماكن حول العالم للقيام بأنشطة عسكرية بيولوجية.
ولم يتضح بعد لغز الصلة بين معمل فورت ديتريك وانتشار الجائحة حتى الآن.
وقال هيوم فيلد، مستشار العلوم والسياسات للأعمال المعنية بالصين ومنطقة جنوب شرق آسيا بتحالف الصحة الإيكولوجية في نيويورك، إن تسييس تتبع الأصول يولد “الشك” و”عدم الثقة”، ويقوض بشكل أساسي الجهود العالمية الموحدة اللازمة للتغلب على هذا الفيروس وهذا المرض.
التلاعب الأيديولوجي
في أغسطس، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيدعو في ديسمبر زعماء من “الديمقراطيات العالمية” للاجتماع في قمة افتراضية من أجل الديمقراطية، على أن يتبعها “في غضون عام تقريبا، قمة واقعية ثانية”.
ومن المثير للسخرية أن استطلاعا حديثا أجرته مؤسسة تحالف الديمقراطيات بين 50000 مشارك في أكثر من 50 دولة، وجد أن ما يقرب من نصف المشاركين ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها تهديد للديمقراطية.
ومنذ أمد بعيد، تعرف الولايات المتحدة نفسها على أنها “مدينة فوق تل” وتدافع عن القيم الأمريكية مثل “الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان” باعتبارها “قيما عالمية”، وتعتقد أنها تتحمل مسؤولية نشر قيمها في كل أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن مثل هذه “القيم العالمية” في جوهرها هي أداة أيديولوجية للولايات المتحدة للحفاظ على الهيمنة العالمية.
ومن ناحية أخرى، تستغل الولايات المتحدة وضعها القوي في مجالي الثقافة والإعلام لتعزيز الديمقراطية والقيم الأمريكية بالقوة في العالم، خاصة في البلدان النامية. ومن ناحية أخرى، وتحت ستار ما تسمى “القيم العالمية”، تحاول الولايات المتحدة اتخاذ التفوق الأخلاقي للتلاعب بالرأي العام الدولي، والهجوم التعسفي على الدول والكيانات التي تعدها تهديدات ومنافسات، وخلق الانقسامات والمواجهات عن عمد.
وفي عام 2010، الذي شهد تقديم “الإطار الوطني للاتصال الاستراتيجي” من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما إلى الكونجرس الأمريكي، دخل نظام الدعاية الوطنية، الذي تقوده الحكومة الأمريكية، مرحلة بات فيها أكثر قدرة على إجراء عمليات مشتركة بين المؤسسات.
وفي عام 2014، كشف تقرير لصحيفة ((جارديان)) عن برنامج سري تديره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتسلل إلى قطاع موسيقى الراب في كوبا وإطلاق حركة ضد الحكومة الكوبية.
ووفقا للإعلام البريطاني، جندت الوكالة عشرات الموسيقيين الكوبيين لمشروعات مستترة في شكل مبادرات ثقافية، بيد أنها في الواقع تهدف إلى تحريض حركة المعجبين من أجل تحدي الحكومة.
كما ربطت الولايات المتحدة مساعدتها الاقتصادية بالنظام السياسي، للضغط على الدول الإفريقية لاتباع النماذج السياسية الغربية من خلال المؤسسات المالية الدولية بقيادة الولايات المتحدة.
منذ الثمانينيات، جعل الرؤساء الأمريكيون الترويج لـ”الدمقرطة” في البلدان المتلقية هدفا رئيسيا للمساعدات الخارجية الأمريكية.
إلا أن مثل هذه التحركات غالبا ما جلبت الكوارث إلى البلدان المتلقية.
فقد أدت عملية “الدمقرطة” السياسية السريعة وكذا الخصخصة الاقتصادية في العديد من البلدان الإفريقية إلى أزمات سياسية واسعة النطاق بل وحتى صراعات دامية، مع استمرار الاضطرابات السياسية في بعض البلدان حتى اليوم.
وتروج إدارة بايدن لفكرتها المتمثلة في “تبني التعددية مجددا” منذ توليها السلطة، ولكن من الناحية العملية، لا تزال باقية على سياسة التكتلات الصغيرة ومهووسة و الاختلافات الأيديولوجية والقمع التعسفي للبلدان الأخرى لخدمة مصالحها الخاصة باسم حماية “النظام الدولي القائم على القواعد”.
تكمن سيطرة الولايات المتحدة المهيمنة وراء المجموعة الرباعية وتحالف العيون الخمس الاستخباراتي ومجموعة الـ7، وجميع التكتلات المماثلة الأخرى، التي لا يمكن أن تمثل المجتمع الدولي بأي حال من الأحوال.
على سبيل المثال، جمعت إدارة بايدن كلا من بريطانيا وكندا وحلفاء آخرين للإثارة المتكررة في مجلس حقوق الإنسان الدولي لاتهاماتهم الكاذبة ضد التقدم في مجال حقوق الإنسان بالصين، لا سيما الادعاء بما يسمى “العمالة القسرية” في شينجيانغ.
وفي الوقت نفسه، فإن التاريخ المؤسف لتلك البلدان من الإبادة الجماعية والانقراض الثقافي، فضلا عن مآسي التمييز العنصري التي تحدث في الوقت الحاضر في ساحاتهم الخلفية، يتكشف باستمرار للعامة.
وفي الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان الدولي، وجهت أكثر من 90 دولة نداء من أجل العدالة، معربة عن دعمها للصين وقائلة “لا” للتكتلات المناهضة للصين.
وقالت مجلة ((فورين أفيرز)) الأمريكية في مقال نُشر في 9 يوليو إنه “من جائحة كوفيد-19 إلى قواعد التجارة العالمية، ومن تغير المناخ إلى التنمية الاقتصادية، تعمل الولايات المتحدة بنشاط على إحباط أولويات معظم الديمقراطيات في العالم.
وفي هذه العملية، فإن السياسة الخارجية للولايات المتحدة ــ باسم الديمقراطية ــ تزيد من تفاقم الأزمة العالمية للديموقراطية وتنزع الشرعية من القوة الأمريكية”.
وقال العالم السياسي البلغاري إيفان كراستيف في مقال رأي نُشر في صحيفة ((نيويورك تايمز)) في مايو “فقدت الديمقراطيات الليبرالية في العالم احتكارها لتحديد ماهية الديمقراطية”.
ونقلا عن استطلاع أجراه مركز (بيو) للأبحاث قبل بضعة أشهر، قال كراستيف إن الغالبية العظمى من الأمريكيين “يشعرون بخيبة أمل شديدة من نظامهم السياسي”، وإن “البعض غير مقتنعين بأنهم لا يزالون يعيشون في ديمقراطية”.
وأظهرت الدراسة أن هذا ينطبق أيضا على العديد من الدول الأوروبية.
وقال جراهام أليسون، الأستاذ في جامعة هارفارد والعالم السياسي الأمريكي الذي روج لمصطلح “فخ ثوكيديدس”، سابقا في مقال في مجلة ((فورين بوليسي)) إن “أحادية القطب قد انتهت، ومعها الوهم بأن الدول الأخرى ستأخذ ببساطة مكانها المخصص لها في نظام دولي تقوده الولايات المتحدة”.